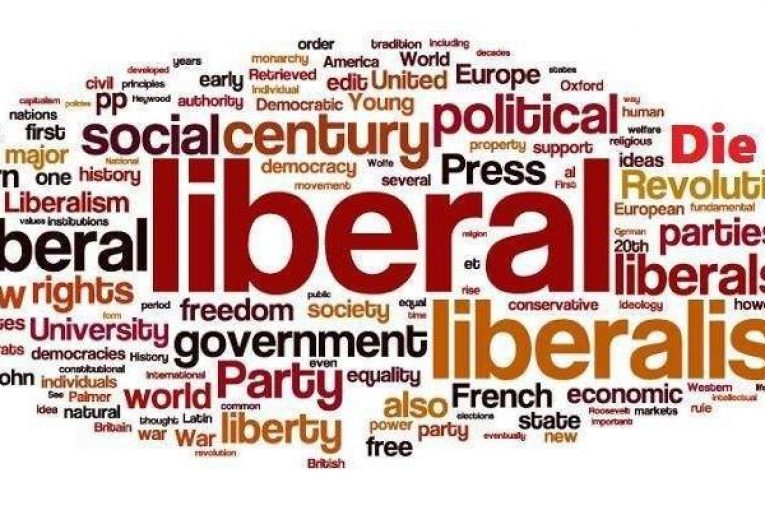
الدّكتور عليّ رّسول الرّبيعيّ – المركز الديمقراطي العربي
ربما ليس التحدي الرئيس الذي تواجهه الديمقراطيات في هذا العصر هو خطر الشمولية بقدر هوما تنتجه التعددية، ووجود مجموعة من الولاءات الثقافية غير المتوافقة داخل هذه المجتمعات التعدية. كيف يمكنها النجاة من انقسامهم إلى جماعات لم يعد الكثير منهم يشاركون في المتطلبات الأخلاقية الأساسية لنظام ديمقراطي: الاعتراف بحرية الضمير، والمساواة في الحقوق، وما شابه ذلك؟
يبدو أن هناك نظريتان رئيستان تقدمان الحل، الجمهورية من ناحية، والليبرالية من ناحية أخرى، ولكن قد يبدو أنها بعيدة عن املامسة لوضع الحالي. ومع ذلك، هل سيساعد المسح التاريخي والمفاهيمي لهذين الخيارين المختلفين في تسليط بعض الضوء على القضايا المعنية؟ ما هو فهمهم للتنوع وهل يمكن لكل منهم أن يتعلم شيئًا من الآخر؟ الهدف من هذه الدراسة هو كشف أن هذين الردين أو الأستجابتين لا يزالان على قيد الحياة إلى حد كبير. أنهم أكثر تشابهًا مما قد يظن به المرء؛ وأن فحصها يظهر بوضوح شديد أن جذر المشكلة يكمن في مضمون المواطنة والكرامة المرتبطة بها، وليس في التنوع في حد ذاته.
لذلك، سأحاول،(1)، شرح السمات الرئيسية للرؤية الفرنسية النموذجية بشأن التنوع والاعتراف بها، والطريقة التي وفرت بها الجمهورية موارد التكامل الثقافي الناجح. سأقوم بعد ذلك (2) بتأكيد أوجه التشابه مع جوانب المفهوم الراولزي لليبرالية السياسية،[1] التي قد تظهرفي البداية بعيدة جدًا ولكنها في الواقع أقرب بكثير عند دراستها بالتفصيل. سأختتم (3) باقتراح موجز لإعادة تقييم المواطنة يتجاوز بمعناها المعنى الاجتماعي في التقليد الجمهوري الفرنسي، ومع ذلك يتجنب مخاطر “سياسات الاعتراف” النموذجية لليبرالية المعاصرة.
السمات الرئيسية للنموذج الجمهوري الفرنسي: الاندماج كـ “استيعاب”
إن الملامح الرئيسية للنموذج الجمهوري الفرنسي هي: الاندماج كـ “استيعاب” فرنسا كأمة، كانت نتيجة مشروع سياسي وتشكيل مجتمع لا يقوم على “الدم”، ولكن على المواطنة بوصف الأمة مجتمع من المواطنين. لقد تم التعبير عن هذا المشروع بقوة من قبل الثورة الفرنسية، لكن له جذور أعمق، لا يمكنني تفصيلها هنا. إن العمليات المزدوجة للتحديث والشمولية العالمية خلال وبعد الثورة الفرنسية تعني أن تصبح فرنسيًا ليس مجرد دخول جماعة أو أمة عرقية معينة، ولكن أن تصبح فاعلًا في دراما أوسع، تلك العملية التحررية التي كانت ستؤدي في نهاية المطاف إلى اتحاد قوميات بطريقة ديمقراطية وسلمية، إلى ملائمة وتسوية الخلافات بطريقة شاملة، وحل الخصوصيات والتماييزات بوصفها مصادر للصراعات، وإلى الاعتراف بنوع من الأخوة العالمية أو المواطنة العالمية. وقد كانت هذه الفكرة، على سبيل المثال، مصدر إلهام لـكانط.[2]
يقوم الدستور الجمهوري على ثلاثة مبادئ: أولاً مبدأ الحرية لجميع أفراد المجتمع؛ ثانياً، مبدأ اعتماد الجميع على تشريع مشترك واحد؛ وثالثًا، مبدأ المساواة القانونية لجميع المواطنين … وأن الجمهورية تقدم احتمالا لسلام دائم … كما هو الحال بموجب هذا الدستور، وإن موافقة المواطنين مطلوبة لتقرير ما إذا كان سيتم إعلان الحرب أم لا، وسيكون لديهم تردد كبير في الشروع في مشروع خطير للغاية.
يبدو أن تصور أو مثال الجمهورية كدولة مدنية هي أفضل حماية ضد الصراعات العرقية أو الطوائفية أجمالا وضد الحربايضاً. كان للثورة الفرنسية امتياز كونها المحرك الأساسي في هذه العملية من خلال تحرير الناس من جذورهم وروابطهم الخاصة و”إعادة إنشائهم” أو تشكيلهم كحاملين حقوق مجردة: لم يعد هناك ألاً مواطن فرنسي له حقوق وكرامة متساوية مع المواطنين الآخرين. لذا، أن تكون فرنسيًا، فإن المسؤوليات الضمنية، تشبه إلى حد كبير تلك التي يحملها المفهوم الأمريكي للمواطنة فيما يتعلق بفوائد المواطنة الحرة والمتساوية، بما يتجاوز الاختلافات بين الطبقات والأصول العرقية واللغة والدين. لقد اخترعت فرنسا مفهوم “الأمة المدنية”، ومثال معين من “الجمهورية العالمية”.
دعونا نفكر أولاً في المعنى الدقيق للأمة المدنية للجمهورية كمجتمع من المواطنين متحد ومتكامل على الرغم من أصولهم الثقافية المختلفة. على النقيض من “الأمة العرقية”، المجسدة في ألمانيا الموحدة المعاصرة، على سبيل المثال ، فإن المشروع السياسي للأمة المدنية لا يأخذ “التجانس” السياسي باعتباره “نوعًا من الظواهر الطبيعية، طبيعة ثانية، كما كانت، لكنه يرى ذلك نتيجة الولاء الطوعي والواعي. إن الأمة لا تُعطي على هذا النحو من قبل الماضي أو الثقافة أو التقاليد، ولكن هذا لا يعني أن البنية الفوقية السياسية تركب بالأكراه من فوق على مجتمع مدني منقسم ومجزّأ. تم إنشاؤه من خلال التحام المواطن بمؤسساته السياسية: الأمة، كما قال إرنست رينان في مقولته الشهيرة، أنها استفتاء يومي. هذا هو أفضل تعريف للجمهورية على أنها خلق سياسي طوعي، نتيجة لميثاق اجتماعي متجدد إلى ما لا نهاية أو” جمهورية الميثاق”. وبالتالي، فإن التعددية الثقافية وتفكك المجتمع إلى جماعات مختلفة متمايزة عن بعضها يهدد مثل هذا المشروع. ستبقى المكونات المختلفة العديدة على حالها في العقد الاجتماعي. سيظلون كما كانوا في البداية: مجتمعات وأفراد معينين بدون مشروع سياسي مشترك. لهذا السبب، إذا كانت فرنسا مجتمع متعدد الثقافات بشكل فعال مثل بريطانيا أو الولايات المتحدة، فإنها لا ترى نفسها على هذا النحو، ولكن لديها مهمة استيعاب هذا التنوع في جمهورية واحدة وغير قابلة للتجزئة، لتحويل هؤلاء الأفراد إلى متساوين ومواطنين متماثلين، وأدخال المجتمعات المحلية الصغيرة المتبقية في الهيئة السياسية غير المتمايزة.
لدينا إذن قراءتان محتملتان لنموذج جمهورية عالمية. فإما أن نرى النموذج الفرنسي للاندماج على أنه قومي وغير ليبرالي، حيث أن نيته الحقيقية، أبعد من خطاب المساواة ، وهي “فرنسة” سكانه، وفرض ثقافة واحدة، لغة واحدة، طريقة تفكير واحدة، بغض النظر عن هوياته المميزة المختلفة وكل هذا باسم التحرر. والأهم من ذلك، يمكننا أن نراها على أنها ترغب في تهيئة الظروف اللازمة لممارسة هيمنة سياسية مركزية قوية. فهي تعتبر وبشكل واضح، من وجهة النظر هذه، أداة للاستعمار والإمبريالية الداخلية والخارجية، أو يمكننا رؤيتها كطريقة فعالة لتجنب القومية -العرقية، بسبب الطبيعة السياسية للأمة، وقوة لأمة موًحدة واحدة. وأن المجتمع يأتي من مؤسساته السياسية، وليس من نقائه العرقي. هذه ميزة مهمة للغاية على المرء أن يأخذها في الاعتبار قبل أن ينتقد نموذج الجمهورية، خاصة عندما يفكر في محاولة صياغة مفهوم مماثل لألمانيا المعاصرة، مفهوم”الوطنية الدستورية ” الذي طرحه الفيلسوف يورغن هابرماس وفشلها الأخير في الفوز على نطاق واسع القبول، منذ إعادة توحيد ألمانيا وصعود القومية الألمانية في التسعينات. يمكن أن يكون الحفاظ على التوازن بين العالمية والخصوصية أحد مزايا هذا النموذج؛ ويمكن تجنب مركزية العرقيات إذا نُسبت العالمية فقط إلى المؤسسات السياسية للدولة وليس إلى التقاليد الثقافية التي نشأت فيها.
لقد تم اعتبار الاستيعاب، منذ ظهور “سياسات الاعتراف”، أنه يؤدي الى فقدان الهويات تقاليد وقيًم ثمينة لا يمكن تعويضها، ونُظر اليه بهذا المنظار غير الجذاب. لكن طالما كان، اعتمادًا على سمات السكان المهاجرين، وعلى ميزان القوى، وفي الغالب، على مدى الحقوق والمزايا المرتبطة بالمواطنة، مرادفاً لنوع من التحرر والتحديث وخلق مساحة تنفس جديدة لتطويرها في لغة جديدة. من هذا يمكن أن نجد العديد من الأمثلة البليغة. واحدة من هذه هي لليهود والثورة الفرنسية التي منحتهم ، في عام 1789 ، وضع المواطنة المتساوية لأول مرة. وهذا يعني مكسبًا كبيرًا في الأمن والكرامة وآفاق الحياة الأساسية. وهذا يعني مكسبًا كبيرًا في الأمن والكرامة وآفاق الحياة الأساسية. على سبيل المثال ، حق الملكية الكاملة للممتلكات التي حرمت على مدى قرون لغير المسيحيين في البلدان المسيحية. كما شهد ذلك القول الشهير: “سعيد كالله في فرنسا!”. هنا ، لدينا حالة من التأقلم بدون خسارة الهوية بشكل عام (على الرغم من أن هذا الادعاء يحتاج بوضوح إلى تحليل دقيق لمفهوم الهوية الدينية مسلمة أو يهودية ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى السمات الخاصة للدين الإسلامي، وجزئياً بسبب محتوى حقوق المواطنين. وبما أن المواطنة تضمنت الحق في العبادة ، فقد سمحت بإمكانية الاستمرار في كون الشخص مسلما أو يهوديا كمواطن فرنسي . كان القيد الوحيد الذي فرضته الجمهورية العلمانية على المواطنين وحقهم في العبادة هو أن ممارسة الدين يجب أن تبقى خاصة، حتى لا تغزو المجال العام.
وبالتالي، يجب على المرء ألا يستهين بجاذبية الاستيعاب عندما يعني مجموعة واسعة من الحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية تنمية الهوية الشخصية والحصول على الاعتراف بها واحترامها في إطار وقيود المواطنة. لقد تم الأستياء من سياسات الاستيعاب في الغالب عندما أصبح مضمون المواطنة ضعيفًا، وعندما تآكلت قيمة الحقوق الأساسية كما هو الحال في حالة المهاجرين من شمال إفريقيا في فرنسا. يمكن أن ينظر إلى الاستيعاب من الخارج على أنه عملية غير ليبرالية للغاية، ولكن بالنسبة للسكان يمكن أن تكون الفوائد هائلة طالما أن القيمة السياسية والاجتماعية للمواطنة مستدامة. أطروحتي هي أن قيمته الأخلاقية يجب أن تؤخذ في الاعتبار أيضًا.
كانت الأداة الأساسية والأكثر وضوحًا لسياسات الاستيعاب هذه هي الدولة الفرنسية القوية والمركزية. لا يجوز الخلط بين الدولة والأمة. الدولة أداة الأمة .. كانت أولاً أداة إنشائها ثم توطيدها. انها تؤمن ديمومة الأمة حيث تواجه الأخيرة أخطار داخلية وخارجية. تقوم شرعية سلطة الدولة على مثال او تصور تجريدي للأمة المدنية. المطلوب أن تكون الدولة قوية لأنه، نظرًا لأن الأمة لا ترتكز على مجتمع “طبيعي” أو عرقي، على النقيض من الأمة المدنية أو “الثقافية”[3]، فإن عوامل الأنحلال متعددة. يمكن للمرء أن يشرح بسهولة حالة “الدولة” في فرنسا من خلال إعطاء أسباب تاريخية، ولكن أيضًا بالإشارة إلى أهمية عوامل زعزعة الاستقرار وعدد المجتمعات الإقليمية المتنوعة التي كان يجب استيعابها و “فرنستها” من خلال نوع من الاستعمار الداخلي منذ العصور الوسطى. وعلى النقيض من ذلك، كانت عملية الاستيعاب في بريطانيا الحديثة، بشكل عام، أكثر سلاسة وأقل استبدادًا باستثناء أيرلندا.
يرى المرء بوضوح، لماذا كان إنشاء الدولة لنظام تعليمي عام وإلزامي وعلماني ومجاني بالكامل بين عامي 1880 و 1905 ضرورة مطلقة للجمهورية: كان أفضل طريقة لاستيعاب السكان المتنوعين وخلق أساس متين للأمة المدنية. ولكن، مرة أخرى، يمكن تفسير هذه السياسة أيضًا على أنها تهدف إلى الهيمنة السياسية، وليس إلى إنشاء دولة مدنية. إن دور النظام المدرسي، وفقًا لوظيفة الدولة، كان بلا شك تشكيل عقلية وعواطف الناس العاديين من أجل إنتاج “مواطنين صالحين”.
يجب على المرء أن يتوقف هنا ويفكر في سمة ملفتة للنظر في المثل الجمهوري، وهي الصراع الدائم بين الفرد المستقل والمواطن أو، في مصطلح روسو، بين الإرادة الخاصة والإرادة العامة. إن معنى هذا الصراع هو أكثر تاريخية حتى مما تنقله المفردات الروسوية. إنه في الواقع صراع بين الخصوصيات الإقليمية والاجتماعية التي كانت السمة المميزة للنظام القديم وتفاوتاته العميقة من جهة، والوحدة المجردة للأمة المدنية من ناحية أخرى. إن الخلط بين التنوع أو الأختلاف وعدم المساواة، حيث يصبح الأول مرادفاً للاستعباد، هو مفهوم سخيف، ولكنه مع ذلك له جذور تاريخية عميقة للغاية. إن الإنسان، الذي يتميز بولاءاته، ويعرف نفسه بمجموعات معينة من مصالح جماعية أو مصالح فردية، لا يمكن أن يكون مواطنًا صالحًا. المواطن الصالح، أولا وقبل كل شيء، لا ينتمي إلى أي من هذه الولاءات. لكن هل المواطن يصنع الجمهورية أم أن الجمهورية هي التي تصنع المواطن؟ إن الارتباط المتبادل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المدرسة والتربية، بما له أولوية أو يتجاوز أي احترام العائلة أو الروابط المجتمعية، وحتى بالنسبة للتقاليد، مهما كانت عظيمة. فالمدرسة ليست في خدمة الأسرة ولا أرباب العمل. وظيفتها الوحيدة هي تشكيل العقل، دون أي اعتبار للمصالح أو المعتقدات وإحضاره إلى أعلى مستوى من الحرية. تعترف الجمهورية بالمعتقدات الفردية، ولكن فقط لما هو مستحق لأي إنسان، ليس باسم التعددية؛ فهذا من شأنه أن يتعارض مع الاندماج ويؤدي إلى التمييز عندما يتم الإشارة إلى الأصول الدينية أو العرقية من قبل المؤسسة، حتى من خلال بطاقة الهوية![4]
هناك الكثير للتعليق عليه هنا. ما وراء النغمة الاستبدادية: “المدرسة لديها صلة أساسية بالحقيقة”[5] يجب على المرء أن يدرك الإرادة لخلق نوع جديد من البشر، المواطن، الذي لم يعد فردا يُحدد بئانتماءاته. هذا ، بالطبع ، أكثر الاختلافات اللافتة مع التقليد الليبرالي البريطاني حيث يتم التركيز على الفرد وعلى “ثقافة الذات”، كما يظهر من بلاغة جون ستيورات ميل في كتابه ” الحرية”. يتعلم المرء كيف يصبح فرنسيًا من خلال دراسة المفكرين والكتاب العظماء والشخصيات المهمة التي لعبت دورا في تاريخ الأمة ، وليس من خلال الاكتشاف الذاتي والتعلم التوليدي السقراطي. وهذا يفسر لماذا ينصب التركيز، في مناهج المدارس وطرق التدريس، على المعرفة والكفاءة، وليس على الخبرة الشخصية للفرد التي تتعلق بالتنوع، وعدم التجانس، والفوضى، وربما، على أي حال تحديا لقوى التوحيد. أنها تقول الكثير عن إيديولوجية التحرر وفقًا للجمهورية وأن المؤسسين للنظام التعليمييجب أن يكونوا تلاميذ أوغست كومت، وليس جون ستيوارت ميل.[6]
ولكن مرة أخرى ، لا ينبغي للمرء أن ينظر إلى الجمهورية باعتبارها عدوًا للحرية الشخصية “السلبية”، ولكن كأداة سياسية للتكامل داخل دولة مدنية وليست عرقية، حيث المواطنة هي البديل عن التجانس الثقافي. ولادة مجتمع ديمقراطي أصبحت ممكنة بفضل أيديولوجية استبدادية على ما يبدو. السؤال هو إلى أي مدى هو غير ليبرالي.
القضية الأكثر حساسية ، حتى الآن ، هي بالطبع قضية السلام الديني في فرنسا. هذا سؤال صعب للغاية لأن نوع العلمانية التي تطورت في فرنسا كان لها جوانب متناقضة. هناك علمانية براغماتية تقوم على حل وسط مستمر بين الكنيسة والدولة يحاول تلبية المطالب الأساسية المتناقضة. وهناك أيضًا لائكية عدوانية، تريد “تحرير” الناس من ارتباطهم بالكاثوليكية والقوى الظلامية. تصبح هذه العلمانية بكل سهولة صورة كاريكاتورية للدين المدني الذي حلم به، على سبيل المثال، روسو.[7] إن القصة بين المشاعر والتنازلات هي القصة الحقيقية للعلاقات بين الدولة والكنيسة الكاثوليكية، أنها قصة ظهور الحياد فيما يتعلق بالمعتقدات المختلفة المعترف بها على أنها “شخصية وحرة ومتغيرة”.
الجمهورية والليبرالية السياسية
نجد بعيدًا عن التناقضات، إن أوجه التشابه بين مذهب الجمهورية بالمعنى الفرنسي والليبرالي السياسي هي حقيقية وينبغي أن تقودنا إلى النظر إلى كلاهما كإجابات متشابهة عن التحدي نفسه . يشترك المفهومان تاريخياً في المشروع نفسه لإنشاء دولة أمة تجسد المثل الأخلاقية وتؤدي إلى التعايش السلمي، على الرغم من أن تجسيد المشروع اتخذ أشكالًا مختلفة. أنها تنشأ من الناحية المفاهيمية، في مجموعات مماثلة من الأفكار تعود إلى عصر التنوير مثل : فكرة العقد الاجتماعي. مفهوم العدالة الإجرائية ؛ أولوية الحق على الخير ؛ أولوية الحريات الأساسية على المنفعة؛ تعريف الاستقلالية كمصدر لادعاءات التحقق الذاتي؛ التوتر بين المساواة والحرية ضمن التقليد الليبرالي للحقوق الطبيعية؛ الفصل بين المجالين العام والخاص. من المثير للاهتمام التأكيد على أن المشاكل التي واجهتها الليبرالية في الآونة الأخيرة هي أيضًا مشاكل الجمهورية.
أفترض أن الليبرالية السياسية تعني ما أكد عليه جون راولز في كتابه الأخير،[8] أي المفهوم السياسي للعدالة الذي يمكن أن يكون بمثابة أساس لتوافق الآراء بين وجهات النظر المنقسمة بشدة والمتضاربة حول الخير الذي يمتلكه المواطنون المعقولون والمتعاونون. هدفها هو مقارنتها مع الليبرالية الشاملة. إن الليبرالية الشاملة، كما هي عند كانط أو جون ستيوارت ميل، هي منظور ليس لأساس الارتباط السياسي فقط ، ولكن لكل الحياة البشرية. إن تأكيدها على أولوية الحرية له أسس مادية في مفهوم فردي للعقلانية والإرادة. إن التأسيس الفلسفي لمؤسسات مجتمع تعددي ديمقراطي على مثل هذا المنظور سيكون غير عادل وغير فعال لأن الناس الذين لا يتشاركون في العقيدة العلمانية الفردية سوف يكرهون بشدة تأثيرها على المؤسسات الرئيسية التي تشكل حياتهم وحياة أسرهم. فماذا عن التعليم الليبرالي، إذا كنت شخصًا متدينًا تقليديًا بعمق؟ قدم رولز إجابة الليبرالية السياسية على هذا السؤال: لليبرالية السياسية هدف مختلف ومتطلباتها قليلة. تطلب أن يشمل تعليم الأطفال أشياء مثل معرفة حقوقهم الدستورية والمدنية بحيث، على سبيل المثال، يعرفون أن حرية الضمير موجودة في مجتمعهم وأن الردة ليست جريمة قانونية.[9] هذا يعني أن الليبرالية السياسية تهتم بالمواطن فقط في المجال السياسي، وليس بما يحدث في المجال غير العام طالما تم الامتثال لمبادئ العدالة الأولى. وبهذا المعنى، فإن الليبرالية السياسية أقرب إلى الجمهورية من ما يُعرف بالليبرالية الشاملة.
تدعي الليبرالية والجمهورية على حدٍ سواء أن للمواطنة مضمون أخلاقي، وكرامة مرتبطة بها، ولكن مضمون “رقيق”، ولا يتضمن أي وجهة نظر دينية أو فلسفية. يكمن هذا المضمون الأخلاقي “الرقيق” في الاعتراف بحكمة الفرد المعقولة وهو ما يسمح بإمكانية الحصول على موافقة سياسية. ومع ذلك، يؤدي تفسير هذه المعقولية إلى إجابات مختلفة. يقسم الجمهوريون أنفسهم بالنسبة للجمهورية، في السياسة كما في الأمور التربوية، إلى المتدينين الذين يرغبون في تعليم التعليم الديني الجمهوري، والمعتدلون الذين يرغبون في احترام حرية الضمير. لدينا، من ناحية أخرى، تقليد اليعاقبة وتأثير واسع النطاق لشك روسو في الفرد؛ حيث إن المواطن فقط، الذي تلقى تعليمه من قبل الدولة ويبدي الألتزام بالفضائل المدنية اللازمة للإرادة العامة، على خلاف الرغبات الخاصة، هو الذي يمكن الوثوق به في “طاعة العقل وليس الغريزة”. يكون الفرد كائنًا تقدميًا واجتماعيًا و، طبقاً لوجهة نظر أوغست كومت بشأن التحديد الاجتماعي للطبيعة البشرية؛ وإن المعقولية ليست تعبيراً عن الفضيلة، بل هي نتيجة التعليم والحياة الاجتماعية.[10] ليست هذه الصيغة في جوهرها غير ليبرالية مثل اليعقوبية حتى لو وجدنا فيها ميلًا إلى الاستبداد، كما تظهر مقالات كومت وميل بطريقة مضيئة للغاية ولا تعارض على الإطلاق السمات الرئيسية لليبرالية السياسية.[11]
تجعل ما يسمى بالتعددية المعقولة،[12] من الممكن للدولة ومواطنيها احترام تعددية الآراء المتضاربة التي تشكل ثقافة الديمقراطيات المعاصرة. إذا كان الناس قادرين على إدراك أن الآخرين قد يكون لديهم معتقدات مختلفة عنهم ويظلون معقولين، فيمكنهم جميعًا أن يشكلوا “مجتمعًا للتبرير” على الرغم من اختلافهم لأنهم جميعًا يدركون حدود ما يمكن تبريره، وهو ما يطلق عليه راولز”أعباء الحكم”،[13]هذا الموقف هو جزء مما يسميه راولز “واجب الأدب”.[14] ينطوي هذا الواجب على الرغبة في الاستماع إلى الآخرين والعقل العادل في تقرير متى يجب أن يتم التوافق بشكل معقول مع وجهات نظرهم”.[15]
وقد وصفها سكانلون بأنها مبدأ الدافع الأخلاقي فيما يتعلق بالعقلانية قائلاً: لدينا “رغبة أساسية في أن نكون قادرين على تبرير أفعالنا للآخرين على أساس أنه لايمكنهم رفضها بشكل معقول”.[16] إن هذه القدرة على التعرف على أسباب أخرى غير أسبابنا المقبولة، حتى لو لم نتمكن من مشاركتها، هي أساس المشاركة الأخلاقية في الأتحاد السياسي. يقع مفهوم التسامح هذا في قلب الليبرالية السياسية. أنه يعني بدون وجود مجتمع التبرير، لا يمكن أن يكون هناك ارتباط سياسي. ولكن لا يجب أن يكون هذا المجتمع موحدًا من خلال رؤية مشتركة للمصالح، لأن هذا من شأنه أن يؤثر على حرية اختيار غاياته الخاصة التي يمكن لكل عضو أن يدعيها حقًا. يجب أن يقتصر الإجماع باسم العدالة، على وجهة نظر المبادئ المنظمة للتنظيم السياسي على هذا النحو، ولا يجب أن يتجاوزه.
تجعل النظرة إلى الاحترام كأساس معقول لتوافق أخلاقي مشترك في المشروع السياسي لليبرالية والجمهورية العدو المشترك لكليهما هو مفهوم يعتبرالعضوية السياسية على أساس الولاء الثقافي. يمكن بسهولة، في مثل هذه النظرة، التضحية باحترام الذات لتحقيق الأهداف الأعلى للمجتمع، فعلى المرء أن يضع في اعتباره أنه في معظم الأحيان كانت التجسيدات التاريخية لمشروع أمة مدنية مختلفة للغاية لدرجة أنها كانت تميل إلى إخفاء الأرضية الأيديولوجية المشتركة. إن الانقسام الحقيقي بين الأمة المدنية والعرقية، وليس بين الجمهورية والليبرالية اللتين تشتركان في الواقع في مفهوم مشترك للمواطنة والكرامة المرتبطة بها.
دمقرطة الجمهورية وإعادة تقييم المواطنة
الفكرة الرئيسة التي أود أن أشدد عليها بإيجاز هنا هي أن هناك حاجة لإعادة تقييم مفهوم المواطنة داخل كل من التقاليد الجمهورية والليبرالية ليس لتطور “سياسات الاعتراف” من أجل تقديم إجابة مناسبة لتحديات التعددية؛[17] لكن سيؤدي مثل هذا التحول في مضمون المواطنة إلى ديمقراطية أكبر، أي، كما يوضح راولز عن حق، إلى مزيد من الاحترام لاحتياجات ومصالح وتنمية المواطن كشخص أخلاقي.
رأينا أعلاه أن أحد الفوائد الرئيسية للاندماج وفقًا للمفهوم الفرنسي للأمة، هو التعليم والقيمة الاجتماعية المرتبطة بالمواطنة. يعوض ذلك فقدان الهويات المحلية باسم الوصول إلى منزلة جديدة. كانت القصة الفرنسية أكثر من حركة اجتماعية، والوضع الاجتماعي المكتسب من خلال المواطنة أكثر من قصة تطورأخلاقي شخصي. يتحدث النموذج الجمهوري، المستوحى من العصور اليونانية واللاتينية، عن الفضائل المدنية وقيمة المشاركة السياسية كمصدر للكرامة. لكن هذا يعتمد على المزج بين احترام الذات الذي ينتج بشكل أساسي من خلال الاعتراف العام واحترام الذات الذي يضيف إلى هذا البعد التقدير الداخلي. [18] وعلى النقيض من ذلك، لا يعتمد النموذج الليبرالي للمواطنة والكرامة المرتبطة بها، وخاصة تلك التي يمتلكها جون ستيوارت ميل، على المشاركة السياسية بقدر ما يعتمد على التنمية الذاتية وعلى الاعتراف العام بها. إن احترام الذات والاعتراف بالشخصية القيمة لحياتنا وأنشطتنا لا تنبع بالضرورة من العمل مع الآخرين، ولكن من القيمة المعترف بها للسلوك المستقل في مجتمع حر. وهكذا، فإن المؤسسات السياسية، ولا سيما تلك المعنية بحماية حرية الضمير، يُدعمها مواطنون أحرار ومتساوون ليس فقط كأدوات لتحسين عضويتهم، ولكن أيضًا لأنها تحمي تنميتهم الأخلاقية الشخصية.
عندما تحدثت جوديث شكلار[19] عن ضرورة فصل الإنتاجية أو العمل أو المنفعة، من ناحية، والمواطنة، من ناحية أخرى، وفقًا لمفهوم راولز للمواطنة، قصدت تقييم المواطنة كوسيلة للتوفيق والوفاء الأخلاقي والمكانة؛ تتمتع بها ليس لأنك مفيد للمجتمع، ولكن لأنك جزء منه متساوٍ مع اي جزء اخرومُنحت الحقوق نفسها لتصبح شخصًا مستقلاً وعليك الواجبات نفسها مثل أي عضو آخر مفيد أو أقل فائدة. قصدت ذلك بالضبط ؛ يجب تقييم المواطنة كوسيلة للمثابرة والامتثال الأخلاقي والمكانة؛ تستمتع به ليس لأنك مفيد للمجتمع، ولكن لأنك جزء متساوٍ مع الاجزاء الأخرى منه ومُنحت الحقوق نفسه لتصبح شخصًا مستقلاً ونفس الواجبات مثل أي عضو آخر ، موظف أو عاطل عن العمل ، مفيد أو أقل فائدة. هذه هي القيمة السياسية الأخلاقية المركزية لاحترام الذات التي يتم تدميرها إذا تم قياسها مقابل السلع التي تنتجها أو تمتلكها أو غيرها ، تمامًا مثل تدميرها إذا تم رؤيتها فقط من حيث الحالة الاجتماعية.
تجيب كل من الحركة السياسية الليبرالية والجمهورية على تحديات التعددية من خلال التركيز على قيمة المواطنة. تتمثل إحدى طرق تعليم التسامح واحترام الآخرين في التأكيد على الكرامة المتساوية للمواطنين كأشخاص مستقلين ومعقولين: هذا هو الحل الليبرالي. طريقة أخرى هي التأكيد على الكرامة المتساوية التي خلقتها المشاركة السياسية: هذه هي كانت الإجابة الجمهورية. يشتركان كلاهما في الهدف الطويل الأجل للأمة المدنية كمجتمع للمواطنين، بغض النظر عن أصولهم الثقافية وانتماءاتهم. يجب أن يكون هذا الهدف قابلاً للتحقيق إذا تم التركيز على المشكلة الرئيسة، وهي التركيز على القيمة الحقيقية للمواطنة والمساواة في الحقوق. إن الرغبة في التمايز والانفصال الثقافي ناتجة عن عجز في المواطنة والكرامة المرتبطة بها، وليس وليس برغبة شائعة مفاجئة لا يمكن تفسيرها.
[1] Rawls, J. 1993. Political Liberalism. New York: Columbia University Press.
[2] Kant, I. 1991. Kant: Political Writings, ed. Hans Reiss, Second enlarged edition. Cambridge: Cambridge University Pres. 99-100.
[3] Anderson, B. 1983. Imagined Communities: Reflections on the Organ and Spread of Nationalism. London: Verso.
[4] Muglioni, J. 1994. ‘The Republic and the School’, Political philosophy, no. 4., 73-87. p. 75.
[5] المصدر نفسه، ص 77
[6] Kriegel, B. 1985. ‘Founding citizenship’, in Storti and Tarnero (eds.),
The French identity. p. 84.
[7] Rousseau, J. J. 1991. Social Contract (1762), trans. C. Betts. Oxford: Oxford University Press., IV, eh. 8.
[8] Rawls, J. 1993. Political Liberalism. New York: Columbia University Press.hs. IV and VI.
[9] Rawls, J. 1993. Political Liberalism. pp. 199-200.
[10] Condorcet, A. 2012, Political Writings (Cambridge Texts in the History of Political Thought
[11] Mill, J. S. and Comte, A. 1899. letters from J. S. MiLL to Auguste Comte, 1841-1847, ed. Levy-Bruhl.
[12] Cohen, Joshua. 1993. ‘Moral Pluralism and Political Consensus’, in D. Cop, J. Hampton and J. Roemer {eds.), The Idea of Democracy. Cambridge: Cambridge University Press., pp. 281-282.
Rawls, J. 1993. Political Liberalism, p. 36.
[13] Rawls, J. 1993. Political Liberalism, pp. 54-58.
[14] Cohen, Joshua. 1993. ‘Moral Pluralism and Political Consensus’, 284.
[15] Rawls, J. 1993. Political Liberalism,, p. 217.
[16] Scanlon, T. M, 1982. ‘Contractualism and Utilitarianism’, in A. Sen and B. Williams (eds.), Utilitarianism and Beyond. Cambridge: Cambridge L’niversity Press. p. 117
[17] Taylor, C. 1994. ‘The Politics of Recognition’, in A. Gutman (ed.), 1994.37.
[18] Sachs, D. 1981. ‘How to Distinguish Self-Respect from Self-Esteem’, Philosophy and Public Affairs 10, 346-360.
[19] Shklar, J. I 991. American Citizenship. The Quest for Inclusion. Cambridge, Mass. Harvard University Press., p. 96.
