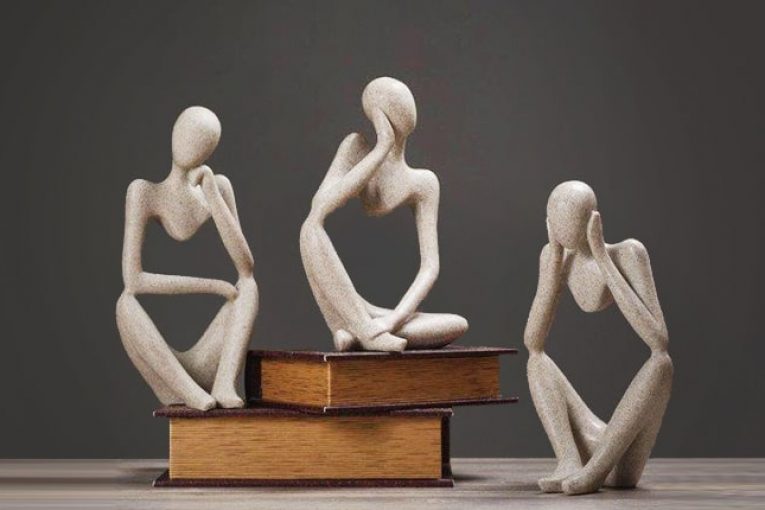
يوسف الحسن
أبدأ بالتساؤل، عمّا إذا كان المثقف العربي يملك سلطةً في تجديد الفكر العربي؟
- أقول نعم… بوصفه منتج وعي للناس، وقادراً على الإبداع؛ بمعنى أنه قادر على تغيير تصور الناس لواقعهم، وتغيير المفاهيم والذهنيات في إطار الثقافة المجتمعية، وتحرير الفكر من العوائق التي تُقيّده.
- لكن.. هل المثقف في وضع، أو في حالة تمكنه من أداء هذه المهمة، مهمة إعادة بناء الفكر العربي وتجديده؟ الفكر العربي بتياراته المتنوعة: قومية وإسلاموية ويسارية وليبرالية (إذا جازت هذه التسميات).
- لنعترف بأن الدور الفاعل للمثقف العربي، قد تراجع بفعل عوامل موضوعية وذاتية، من بينها: الضعف في الحريات العامة، وفي مراكز التفكير، في المجتمع الأهلي، طلاق بين التنمية والثقافة، نخبوية زائدة، انتماءات أيديولوجية أكثر من اللازم، غياب الأولويات، غياب المشروع الثقافي النهضوي قطرياً وقومياً، تعثر في النظم السياسية العربية انعكس على النتاج الثقافي، ضعف المأسسة في حياتنا، تخدير الحس النقدي… إلخ.
- كان مأمولاً أن يكون المثقف العربي الضمير الشقي الذي لا يرتاح للأمر الواقع، بل يسعى لتفسيره وتغييره، لكنه اليوم قلق وحائر، وغالباً في حالة ذهول أمام التحولات المتسارعة حوله.
- من منَّا كمثقفين… توقع أن «بَجَعاً سوداً» من الشباب ستخرج بقوة إلى الشوارع العربية، تحتج ضد القبح والفساد والبطالة والتنمية المعاقة، والمحاصصة والطائفية، والاستباحة الخارجية للأمن القومي.
- كنا نعتقد أنه جيل سطحي، استهلاكي، لا يقرأ، وأنه جيل الجينز والفيسبوك… إلخ .
- لنعتذر للشباب، الذين قصّرنا في فهمهم، وإدراك همومهم وتطلعاتهم، لقد أهملنا مئة مليون شاب عربي، ثروة هائلة لو توافرت لديهم السبل، لفرزنا بينهم مئات الألوف من العلماء والمبدعين والمبرمجين، ليُدخلوا الوطن في قلب الثورة التكنولوجية الرابعة، ليس كمستهلكين بل كمبدعين. يحق لهذا الجيل أن يطلب من النخب الثقافية والسياسية والاقتصادية الاعتذار.
- إذا أردنا أن نعيد بناء الفكر العربي وتجديده، نحتاج أوّلاً أن نعرف أين نقف الآن. وما الذي نسعى للوصول إليه، في المفاهيم والقيم والمنظومات المعرفية، وفي كيفية الاستجابة للتحديات، وتحويلها إلى فرص.
- إن في المشهد الفكري السائد، الكثير من السلبيات والنواقص… ومن بينها الظواهر السلبية التالية:
– جمود الخطاب الثقافي والفكري، في مضمونه ومشاغله، فضـلاً عن ضعف دوره كأداة للإنتاج النظري، وعجزه عن بلورة منظومة معرفية تتفاعل مع العصر، وتتعامل مع التحولات، وتُولّد أسئلة جديدة، تتعلق بقضايا الإنسان العربي المعاصر، وعلاقته بالآخر المغاير والكون، وقضايا الديمقراطية والمشاركة والدولة الوطنية والمواطنة المتكافئة المتعاقدة، والثقافة النقدية والنهوض والتجديد الحضاري والحكم العصري الرشيد.
- وفي المشهد أيضاً، تغيب ثقافة المراجعات، وثقافة التوقع والاستشراف، ولا تملك ثقافتنا الراهنة القدرة على توقع المستقبل، وكل التحليلات التي قدمها مفكرون عرب في العقود الأخيرة لم تستشرف الغد. كما تحضر ذهنية المنفعة الضيقة البدائية، والنمو المتزايد في الوعي الذاتي الفئوي، والنزوع الشبق إلى السلطة وشهوة الحكم حتى لو هُدّمت أعمدة خيمة الوطن.
- وفي المشهد الفكري أيضاً، شيء من الرخاوة أو الضبابية في التعامل مع قيم النزاهة ومواجهة الفساد. وتداول السلطة في مؤسسات وأطر العمل النقابي والأهلي والشعبي والثقافي، والميل الغَلّاب إلى الشعارات، والخطاب الأيديولوجي المتعصب، والموقف الشخصي بدلاً من الخطاب المعرفي العلمي.
- وفي الحصيلة، يمكن القول إننا أمام غياب لمشروع فكري نهضوي حضاري عربي، يتعامل بإبداع مع متطلبات العصر وتحولاته، ويواجه التخلف والتسلط والفساد والتمييز والتجمد التراثي. ويملك الرؤية النافذة، والإرادة والآليات اللازمة.
- ما الذي نسعى إليه – إضافة أو مراجعة؟ سأكتفي بذكر أربع قضايا مهمة:
الأولى: تتعلق بالموروث الثقافي في الوعي، وفي الذهنية الجمعية العامة، حيث من الصعب أن يكون الطريق إلى الحداثة الفكرية سالكاً، وقطع شوطه الطويل إلّا بإعادة مراجعة ونقد هذا الموروث. بمعنى فهمه في تاريخيته، وشروط زمانه ومكانه، وإعادة إحيائه للإجابة عن بعض معضلات العصر، أي قراءة عصرية للتراث في الفكر العربي المعاصر، وتأسيس هذه القراءة على قواعد البحث العلمي، بعيداً من التوظيف السياسي والأيديولوجي.
إنها مهمة معرفية، أن يمتلك الفكر العربي الجديد الشجاعة الأدبية والإنصاف، وحماية حق العقل، والأمن الثقافي للمجتمع.
الثانية: تتعلق بمنظومة قيم وثقافة التسامح والسلم الاجتماعي.
- حيث يواجه الفكر العربي اليوم، أسئلة متجددة، ذات علاقة بمعايير الانتظام والعيش المشترك في المجتمع الواحد، وبين المجتمعات الأخرى، وفي صدارة هذه الأسئلة، سؤال إدارة التنوع والاختلاف في أبعاده المتنوعة، من ثقافية ورؤى فكرية وسياسية ودينية وحقوقية.
- ويتجسد هذا السؤال في مصطلح التسامح بمعناه الحديث، الذي جاء ترجمة للكلمة Tolerance كمفهوم وقيمة وثقافة وسلوك، وكمشروع يجسّد قيماً إنسانية، تسعى مختلف المجتمعات لترسيخها وحمايتها من حيث كون هذا المشروع شرطاً من شروط التوازن الاجتماعي والتنوع الثقافي والعيش المشترك في عالم اليوم. وهو عالم تغيرت فيه الهياكل الديمغرافية نتيجة الهجرات السكانية (ثلث المسلمين يعيشون اليوم في مجتمعات ودول غير مسلمة، وثلثا النصارى يعيشون في غير أوروبا).
- إن التسامح، بمعناه المعاصر والمتداول عالمياً، وفي المواثيق الدولية، ليس بمعنى الصفح أو المغفرة أو العفو، وإنما هو القدرة على التحمل والصبر على رأي مخالف أو عقيدة أو ثقافة أو عرق أو ثقافة مغايرة. وفي إطار قيم حقوق الانسان واحترام كرامته كإنسان، وسعياً لتوفير شروط التعايش السلمي والوئام، عبر احترام الاختلاف؛ وتقدير التنوع الإنساني، كحقيقة ربانية وآية من آيات الله في خلقه، وبالتالي هو واجب أخلاقي وسياسي وقانوني في آن.
- التسامح ليس تعالياً على الآخر، ولا تنازلاً عن خصوصية ثقافية أو عقيدة أو رأياً، إنما هو اعتراف متبادل بالاختلاف، تحت سقف التعارف والتعاون والاحترام، ونبذ الإقصاء والكراهية المتبادلة.
- وهو يعني الإقرار بأن البشر شعوباً وأمماً وأعراقاً وألواناً وألسنة ومذاهب، خلقهم الله سبحانه، ليتعارفوا ويتعاونوا ويعمّروا الأرض.
- من دون تسامح، كثقافة وقيم وتشريع، لا يكون هناك سلم اجتماعي؛ ومن دون سلم اجتماعي لا تكون هناك تنمية ولا سعادة ولا حتى عدل.
- ننشد التسامح، ليس فقط كلحظة اعتراض على فكر إقصائي وظلامي تميزي، ومسلكيات تطهير عرقي أو تكفيري، وإنما ننشده لتأسيس وعي قيمي، وثقافة ضرورية لإنتاج شخصية سويَّة وإنسانية، وفكر عربي جديد قادر على التعامل مع تحديات العصر ومقتضياته، وضمان حق الإنسان في الحياة، وضمان كرامته وهي قيمة أسبق من كل انتماء أو هُوية، وهي حصانة أولية للإنسان، ثابتة له بوصفه إنساناً كرّمه الله، وجعله خليفة في أرضه.
- مطلوب في إطار التجديد الفكري، إحياء الضمير والمسؤولية الأخلاقية… واعتبار منظومة القيم ليست مجرد خصال حميدة أو غير حميدة، بل هي، في الدرجة الأولى، معايير للسلوك الاجتماعي والتدبير السياسي والثقافي، ومحددات لرؤية الآخر والكون.
- أما السلم الاجتماعي، فقد مضى على مثقفي وعلماء الأمة ومفكريها، حينٌ من الدهر، لم تكن فكرة السلم الاجتماعي شيئاً مذكوراً، مع أن الإسلام هو دين سلام ووئام ورحمة للعالمين، لا دين احتراب وتعصّب.
وحق السِلْم، هو حق الكافة في الحياة والراحة والسعي في مناكب الأرض. وعمرانها، وهو مصلحة مع الذات أولاً ومع الغير، والتعاون والتعاضد، ومن دون سلم اجتماعي يفقد الإنسان كل الحقوق، وعلى رأسها حق الحياة، ومن أهم قواعده «درء المفاسد مُقدّم على جلب المصالح»، والأخوة الإنسانية، وإقرار الحوار بالتي هي أحسن.
نعم… السلم الاجتماعي هو لمصلحة الجميع
والتنوع… آية من آيات الله في إبداع هذا الكون، وبالتالي ينبغي أن يكون أساساً في الوئام واستيعاب الاختلاف، ليتحول إلى ثراء وليس عداء، ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾.
الثالثة، تتعلق بمفهوم الدولة الوطنية في الفكر العربي المنشود.
لقد أمضينا نحو قرن من الزمان، ونحن نلعن سايكس، وبيكو… (قُسّمنا وجُزِّئنا… إلخ).
ظل الفكر القومي.. وما زال، ينظر إلى الدولة الوطنية… قُطراً مؤقتاً… وربما لا يعنيه كثيراً. وكذلك ظل أصحاب الفكر الإسلاموي… يتجاوزون الدولة الوطنية إلى «الخلافة»… والبعض رأى في الدولة الوطنية جاهلية تستحق الهجرة عنها، ولا تعنيه، لو هدمت أعمدتها ونسيجها المجتمعي. وهناك تيارات فكرية أخرى، لم تعطِ اهتماماً فكرياً كبيراً لمسألة تحصينها وتنميتها وتوفير إدارة رشيدة للحكم فيها.
وفي كل الأحوال، لم يقدم الفكر العربي، ولا النظام الرسمي العربي (الجامعة العربية)، نظرياً وفي ممارساته، ما هو أفضل مما أعطانا إياه سايكس ورفيقه بيكو. وها نحن اليوم، عملياً، نقبض على الدولة الوطنية. مدافعين عن سيادتها وترابها وخريطتها الجغرافية، ونخشى عليها من الاختراق والغرق وتمزُّق نسيجها الأهلي الاجتماعي، ونذود عنها مخاطر التقسيم، ومهددات الإرهاب، وقد تربّت أجيال في ظلها وغنّت أناشيدها… وتحملت أوجاعها وعثراتها، وحلمت بازدهارها، وتكاملها مع شقيقاتها.
آن الأوان… أن يعيد الفكر العربي تثمين قيمة الدولة الوطنية العربية، وينشغل في تعزيز مقتضياتها في هذا العصر، كدولة قوية وعادلة، وبسلم اجتماعي مستقر… دولة قانون ومواطنة متكافئة، وهوية ثقافية عربية؛ دولة نافعة لأهلها وللإنسانية… لا عالة ولا فاشلة… لا تبني الجدران، وإنما تبني الجسور، والتكامل العربي.
إن منطق الدولة الوطنية الحديثة، يفرض نفسه اليوم، على الفكر العربي الجديد، انطلاقاً من ممكنات الواقع، وبعدما عجزت السياسة والاقتصاد والفكر والإرادة، بما فيها الإرادة الشعبية، عن إنجاز وحدة أو فدرالية أو حتى تكامـلاً، على مستوى الأمة.
إن ما نحتاج إليه اليوم، في فكرنا المنشود، هو تعزيز هذه الدولة الوطنية، بمعايير الدولة لكل مواطنيها، التي تتعامل مع أسئلة العصر الجديدة، في الإدارة الرشيدة للحكم وللموارد، وفي الاقتصاد المنتج والتقانة والعدل والبيئة، ورفاه الإنسان وحقوقه وسعادته، وجودة الحياة، والسلم الاجتماعي.
والرابعة؛ إشكالية تجسير الفجوة بين المفكر وصانع القرار، وهي إشكالية تحدث فيها مفكرون كثر، منذ أكثر من أربعة عقود. ولا أدري لماذا كلما سمعت هذا المصطلح (تجسير) تحضر إلى ذاكرتي أغنية شعبية قديمة، تقول: «جسر الحديد انقطع… من دوس رجليّ/مشوار مشيته الصبح… ومشيته عصرية».
ومن ألف هذا المصطلح من المفكرين، منذ عقود، لم يكن يطمع أن يكون الجسر المنشود ذهبياً أو من فولاذ، لكن على الأقل، أن لا يكون خشبياً، ولا يبنى بالتكاذب المتبادل، وإنما بالنيات الحسنة، والإرادة السياسية، وبتوافر الأذن الرحبة التي تسمع وتتفاعل، والبيئة المناسبة للحوار والمناقشة بالتي هي أحسن، لدى دوائر صنع القرار. أما المفكر، فهو الذي يغادر برجه العاجي ليخاطب نبض الناس، ويستشرف لهم المستقبل، ويمتلك المنهج العلمي في تقديم الخيارات، وطرح الأسئلة الاستشكالية، ويُحدث التأثير الإيجابي داخل مجتمعه، وبخاصة على صعيد الفكر التنويري والعقلاني والنقدي والمعرفي. لقد غاب هذا الفكر، أو غُيِّب في العقود الأخيرة، فترك فراغاً هائـلاً في المجتمعات العربية، وعملت الجهالة والظلامية، والطغاة والغلاة، والتخلف الفكري، على ملئه، فكثر اللغو، وعمّت الفتنة والفساد، وتقطعت الجسور، وحضرت الفوضى!
. . .
لنتذكر سر الحياة، وسعي الإنسان الأبدي نحو التجدد والتطوير والتغيير، ونفتح كُوّة في جُدُر اليأس والقلق، ونشعل منارة الفكر، وننشغل في التجديد، استعداداً للمساهمة في صنع المستقبل الأفضل لهذه الأمة.
.
رابط المصدر:
