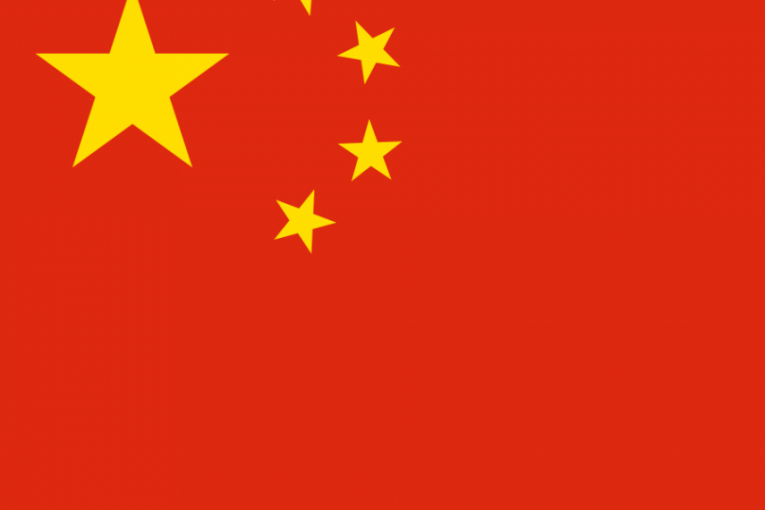
أندريه فورسوف
ترجمة: وحدة الرصد والترجمة في مركز المسبار للدراسات والبحوث.
فشل مؤقت
عند النظر إلى القضايا الصينية في سياق تاريخ العالم، نجد أنفسنا أمام ثلاثة تواريخ مذهلة حافلة بالمتغيرات: 1970، 2020 و1820.
عام 1970، كانت الصين، التي بالكاد نجت من سياسات ومشاريع ماو تسي تونغ، في حالٍ لا يمكن لأي شخص أن يتخيل معه؛ وصولها لما وصلت إليه بحلول عام 2020. حيث تحول هذا البلد لثاني اقتصاد في العالم، يتنافس مع الولايات المتحدة! ولكنّ هذا لم يكن مسار التاريخ كله، فقد كانت الصين في الصدارة قبل هذا الوقت؛ فإذا تعمقنا في التاريخ، وعدنا إلى عام 1820. سنكتشف أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني حينها تجاوز نظيره في أوروبا الغربية مرتين. بالطبع، كانت القوة الأوروبية بقيادة بريطانيا –آنذاك- أكثر تطوراً من الناحية التقنية، وبالمقابل كانت الصين دولة زراعية، إلا أنها من حيث الناتج الإجمالي كانت متفوقة بشكل كبير.
علينا ألا ننسى أن الصين منذ ألفي عام كانت واحدة من أكثر دول العالم تقدماً في المجال الاقتصادي.
لقد اعتدنا النظر للتاريخ، بما في ذلك القرنان الخامس عشر والسادس عشر، من خلال منظور يختزل مراحل تطوره في الأعوام من 1820 إلى 1980 (±) – وفق تصورٍ سيطر على غالبية العالم.
وهنا سؤال: ماذا تعني (100-150) عاماً مقارنة بألفي أو حتى ثلاثة آلاف عام؟ وعنه يتفرّع جواب صغير، إن كان التاريخ يعيد نفسه؛ حين يبدو أن الصين ومعها العالم في 2020، يعودان إلى عام 1820. وهذا الجواب أمامه سؤال كبير: فإلى أي مدى ستكون هذه العودة، منطقية، وهل ستتوقف أم ستخلق منحدرات أكبر؟.
الوقت وحده كفيل بأن يخبرنا عن ذلك.
عام 1820، وصلت الصين لذروة قوتها الاقتصادية، ضغطت عليها بريطانيا العظمى بشكل حاد، بعدما هيأت الساحة لتصدير الأفيون إلى داخل أراضيها، حيث بدأ هذا العمل المربح في نهاية القرن الثامن عشر. مما أدى لقيام حربي الأفيون، وأضعف تمرد تايبينغ سلالة تشينغ الحاكمة، وتمكن البريطانيون في ظل هذه الأجواء من فرض سيطرتهم عبر عدة اتفاقيات تسمى “الموانئ المتعاقد عليها”، والتي حدت -بشكل كبير- من سيادة الصين. في الوقت نفسه كانت المشاكل الاقتصادية للصين تزداد نتيجة لذلك بحلول نهاية القرن التاسع عشر. أصبح يطلق المؤرخون والاقتصاديون على الصين اسم “البلد المتخلف”.
عام 1980، عُقدت ندوة دولية في الولايات المتحدة كان عنوانها (كيف كانت الصين الدولة الأكثر تقدما بالعالم في القرن الرابع عشر)، إلا أنها دخلت في نهاية القرن التاسع عشر مرحلة التخلف –بالمقارنة بالغرب الصناعي- وهو ما أدى لعدم حدوث تحولات اقتصادية واجتماعية تؤدي لخلق تغييرات نوعية.
أدى عزل المناطق الساحلية عن المناطق الجنوبية، إلى نشوء البرجوازية الصناعية، وتعزيز رأس المال التجاري التقليدي، وظهور طبقة “الكومبرادور” الصينية ذات الارتباط الوثيق بمصالح مع دول أجنبية وفي المقام الأول منها بريطانيا العظمى.
كما لم يسد نموذج شنغهاي بعد (اتفاقية نانكين)، التي وضعتها تحت طائلة الامتيازات الأجنبية البريطانية عموم الصين، كما حدث في الهند؛ عبر نموذج مدينة تشيناي “مدارس”، حيث تختلف طبيعة إدراك وتصورات الصين للاقتصاد والسياسة الدولية بشكل جوهري: مقارنةً بالهند أو اليابان، مع حجم الصين وكتلتها الديمغرافية، وثقة الصينيين في تفوقهم الاجتماعي والثقافي على “الغرب”، حتى في أشد الظروف المؤلمة التي تعرض فيها “الشياطين الحمر” للهزيمة، لم يكن هناك مجالٌ لأيّ طرفٍ في أن يشكك في الهوية الصينية. أدت كل هذه العوامل لعدم تحول الصين لمستعمرة، وفي ظل هذه الظروف، لا يمكن للاندماج داخل النظام العالمي إلا أن يشوّه التطور الطبيعي للبلاد.
كانت نقطة التحول الكبيرة في تاريخ الصين الحديثة ما أسميها “الخمسينيات الطويلة من القرن التاسع عشر” 1884-1867/1873. حيث بدأت الأزمة العالمية عام 1848 مع الثورات في أوروبا، ونشر البيان الشيوعي لكارل ماركس وفريدرخ إنغلز، وانتهت مع: بدء إصلاح ميجي باليابان عام 1867، ونشر المجلد الأول لكتاب ماركس رأس المال في العام نفسه، وصولاً إلى الكساد الطويل الذي امتد من 1873 حتى 1896.
فيما أسميها “الخمسينيات الطويلة” ترسخت القوة العالمية في أوروبا الغربية (شمال الأطلنطي) وأصبحت تشكل مركز النظام العالمي الرأسمالي. هذا متغير هام للغاية: إذ يمكن أن يكون بالعالم قوى وأقطاب متعددة. لكن؛ بدا أنّ النظام الرأسمالي العالمي لابد أن يكون بقيادة واحدة، ولا يمكنه التسامح مع الأقطاب الأخرى التي تنافسه على مركز الصدارة في إدارة هذا النظام.
بحلول القرن التاسع عشر كان يسود العالم ما يمكن وصفه بنظام متعدد الأقطاب مكون من أوروبا شمال الأطلسي، بجانب القوتين الصينية والروسية وإن كانتا أضعف.
لذلك لم يكن من قبيل الصدفة أن يشن التحالف الغربي الأنجلو-فرنسي، باعتبارهما جوهر النظام العالمي، حرباً على كلا البلدين في وقت واحد تقريبا: حرب القرم في روسيا (1853-1856). وحرب الأفيون الثانية (1856–1860) في الصين، إلا أن البريطانيين ورفاقهم الفرنسيين؛ لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم بعيدة المدى: كان من غير الممكن هزيمة روسيا؛ وإخراجها بشكل “نهائي” من جنوب أوروبا، خاصة وأنها استعادت جزءاً كبيراً مما فقدته بعد عقد ونصف، كما لم تتحول الصين إلى مستعمرة، ولكن على الرغم من ذلك؛ توقفت كل من روسيا والصين عن السعي لتحقيق أهدافهما في أن يكونا قطبين عالميين، وتحولا مع الوقت إلى قوى إقليمية، وأطرافاً للرأسمالية الدولية اقتصادياً؛ وبشكل جزئي، حيث لم تقع جميع مناطق روسيا والمزيد من الأراضي الصينية داخل الدائرة الاقتصادية العالمية.
على الرغم من الأحداث الدراماتيكية التي يذخر بها التاريخ الصيني، التي استمر بعضها لقرون، فإنّ عاماً واحداً يختلف؛ كل الاختلاف، عمّا قبله، وسيصنع أحداثا تستمر بعده لعقود، عام 1850 الذي جرت فيه انتفاضة تايبينغ، التي معها بدأت متاعب الصين الطويلة؛ وصولا لعام 1949. الذي شهد انتصار الشيوعيين وتوحيدهم للبلاد، وتأسست جمهورية الصين الشعبية.
كانت تلك الفترة تمثل مرحلة تراجع؛ مريع، بعد حكم نموذجي لأسرة تشينغ، يمكن -على سبيل المثال- مقارنتها بعصر حقبة الممالك الثلاث بعد سقوط مملكة هان (المتأخرة): عندما لم يتمكن القائد العسكري تساو تساو من التغلب على تشين شي هوانغ في حروب تشين للتوحيد، أو الصراع الذي نشب بين أسرة تانغ وأسرة سونغ في فترة الأسر الخمس والممالك العشر. على الرغم من أن فترة خلو العرش الصيني من قوة مهيمنة عليه كالمعتاد في العصر الحديث؛ بالنصف الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، منحت الصين مميزات جديدة، فإنها أيضا أدت لتعقيد كبير في تركيبتها الداخلية مقارنة مع “العصر الإمبراطوري” ومع ذلك، بشكل عام لم يتغير جوهر الفشل الصيني، ولم تسقط في “بئر التاريخ” حيث يكون دوماً هذا الفشل لفترة وجيزة وبصورة مؤقتة.
بعد التجارب اليسارية الراديكالية، التي وصلت حد التطرف في بعض الأحيان، وتحولت لما يشبه الحرب الأهلية، كانت الصين في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات في وضع صعب للغاية. إلى أن جاءها الحل لكل مشاكلها من الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها “مركز القوة النووية”؛ للنظام الرأسمالي العالمي، التي خسرت في نهاية الستينيات السباق الاقتصادي مع الاتحاد السوفيتي –لم يفز الاتحاد السوفيتي لكن أمريكا في ذلك الوقت قد خسرت.
كتب ألكسندر سالوماتين منذ عام 1968، في مقالة مثيرة للاهتمام؛ عنوانها “الدولار الافتراضي الثالث أو التذكرة الأخيرة لتايتانيك”: “الولايات المتحدة كمجمع اقتصادي واحد لم تعد مؤسسة مربحة ذاتية التمويل” في الواقع، هذا يعني ما يلي: عام 1968، خسرت الولايات المتحدة الأمريكية المنافسة الاقتصادية مع الاتحاد السوفيتي، واتضح أن الشعب السوفيتي أكثر موهبة واجتهاداً من الأمريكي. لكن القيادة السوفيتية في ذلك الوقت لم يكن في داخلها قائد لامع؛ قادر على إدراك تلك اللحظة واستغلالها مثل ستالين.
مدّت الصين يدها لأميركا
يخلص ألكسندر سالوماتين إلى أن القيادة السوفيتية لم تفهم ببساطة هذه الحقيقة التي فهمتها الصين، ومدت يدها إلى الأمريكيين، وقدمت لهم نفسها على أنها “مصنع العالم”، إلا أن الصفقة لم تنفذ على الفور، فقد استدعت قيام الصين باستفزازين لاختبار النوايا: النزاع على جزيرة دامانسكي 1969، مع الاتحاد السوفيتي، والحرب مع فيتنام 1979؛ التي أقنعت الأمريكيين بجدية بكين، وجرت بعدها ما تسمى “إصلاحات دنغ شياو بنغ” التي دفعت الصين باتجاه الطريق الشبه رأسمالي.
بدأت الصين الشعبية في العمل بنشاط داخل الأسواق الأمريكية والعالمية، حيث ملأتها بسلع رخيصة منخفضة الجودة، وببساطة غير مرغوب فيها. إلا أن هذه البضائع غير المرغوب فيها؛ بفضلها عمل (300) مليون صيني لصالح الإنتاج للسوق الأمريكية، والحصول على دولارات جديدة مطبوعة، وبما أن الديون قد أصبحت مصدر التنمية الرئيس في أمريكا منذ عام 1969، فإن “الاحتفاظ” بهذه الديون من قبل الصين في شكل سندات يساعد الولايات المتحدة أيضا على عدم الغرق.
كان البريطانيون قد سبقوا الأمريكيين في دفعهم الصين للاندماج في الاقتصاد العالمي، لكن بشكل مبكر قليلا عن الأمريكي وتحديدا في بداية القرن العشرين، مستندة على العلاقات القوية التي كونتها بعض العائلات البريطانية مع نخب في جنوب الصين، والتي منها خرج العديد من قادة الحركة الشيوعية.
يشار عادة إلى ما حدث من تطورات اقتصادية في الصين الشعبية على مدى الثلاثين عاماً الماضية بأنه “المعجزة الصينية” وفق معايير معينة يمكن اعتبار هذا الأمر معجزة، حتى لو نسينا أو تناسينا الثمن البيئي والاجتماعي الذي جرى دفعه من ناحية، والوضع الذي تعيشه الصين الآن من ناحية أخرى، ومع ذلك، عندما تم الترويج للنجاحات الصينية وتصويرها على أنها غير مسبوقة في التاريخ، فمن المنطقي –إذن- مقارنتها “بالمعجزة السوفيتية” في الثلاثينيات وخاصة الخمسينيات.
أولا: كان الاتحاد السوفيتي مجتمعاً متطوراً عالي التقنية، والذي وفقاً لمعايير ومستويات ذلك الزمن، لا يمكن مقارنته بالصين الحالية، مع الأخذ في الاعتبار أن الصينيين موهوبون في تلميع نوافذ العرض الخاصة بمنتجاتهم، لقد تحولت الصين لحالة مدنية طاغية، وعلى الرغم من وجود بعض القرى فيها فإن (75%) من أراضيها لم تعد صالحة للزراعة لأسباب بيئية. نتيجة لتطبيق هذا النمط من المسار الرأسمالي الذي يوصف بـ”المعجزة” بينما الاتحاد السوفيتي، يختلف قيميًا، فكان يتصرف كدولة ونظام ومنظومة قيم شاملة، وجدت لتقدم رؤية بديلة عن النظام الرأسمالي العالمي، بل ومعادية له، ونتيجة لهذا التكوين عندما بدأ القادة السوفيت في الاندماج مع النظام الرأسمالي العالمي دخلت البلاد في مرحلة “الموت البطيء”.
لم تكن الصين بكل نجاحاتها رائدة على المستوى العالمي؛ في مجال التكنولوجيا المتقدمة، بل يمكن القول عموما: إن الصين بهذا المجال في “أسفل الترتيب”، إنه وضع طبيعي “للورشة الصناعية” للاقتصاد العالمي الذي لا يمتلك الصينيون أي سيطرة حقيقية عليه.
استفزاز: ليست الصين على شيء من التكنلوجيا!
إن النموذج الصيني بوضعه الحالي ليس خيارا للتنمية يمكن الترويج له أو محاولة استلهامه، كما أنها ليست بديلا عن الرأسمالية ولا تسعى لذلك كونها جزءاً منها ومدمجة فيها، الغرض الصيني الحقيقي وأقصى طموحاتها توسيع منطقة سيطرتها وترقب اللحظة المناسبة التي تصل فيها أمريكا لأقصى مراحل الضعف لتحقق هذا الهدف، ذلك لأنها لا تستطيع أن تأخذ مكان أمريكا وتصبح قوى عالمية مهيمنة جديدة، ليس فقط لأن عالم ما بعد الرأسمالية لن يكون فيه مجال للهيمنة المطلقة. بل لأن الدولة المهيمنة لابد أن تتمتع بقدرة على الإبداع والتفرد، والصينيون لا يمتلكون هذه القدرة، لكن لا شك أن لديهم موهبة على الاستنساخ والتقليد.
سيُغضب هذا الكلام البعض، وربما يصرخ في وجهي أحدهم قائلا: كيف تقول هذا؟! ألم تخترع الصين البارود والبوصلة والورق والنقود الورقية. الإجابة عن هذا الأمر بسيطة للغاية: يمكن ابتكار أي شيء وفي أي مكان، لكن هناك فرق بين الاختراع والابتكار، من أجل أن يصبح الاختراع ابتكارا، هناك حاجة لظروف مواتية: اجتماعية، ومنهجية، وثقافية، ونفسية، على سبيل المثال عرف الرومان الآلات، لكنهم استخدموها في أوقات العطلات لصنع الألعاب الترفيهية؛ كون استخدام الآلات في الإنتاج سيدمر الأسس التي قام عليها نظام العبودية القديم، توصل العلماء الروس البارعون بالقرن الثامن عشر للعديد من النظريات التقنية التي بنى عليها وطورها واستخدمها فيما بعد البريطانيون بكفاءة منقطعة النظير، كون النظام الإقطاعي السائد وقتها لم يكن بحاجة إلى مخترعاتهم، ولم تستطيع البيئة الخاملة نفسيا للروس تقدير قيمة مثل هذه الاختراعات، النخبة السوفيتية في النصف الثاني من الستينيات، ونظراً لأنها كانت تعمل لمصالحها الذاتية أعاقت تحول النظام السوفيتي من قوى اعتراضية على النظام الرأسمالي لقوى معارضة حقيقية لديها مشروع فعال لعالم ما بعد الرأسمالية، كما ينبغي أن يكون وفق الأيديولوجية “الشيوعية” الرسمية للدولة.
بالتالي لا ينبغي علينا الخلط بين الاختراع والابتكار هذا أولا، وثانيا: بين المستنسخين أو المقلدين “وإن كانوا موهوبين” والمبتكرين الحقيقيين. لقد استنسخت الصين، بل و”أخذت” ما وسعها ذلك التكنولوجيا من الآخرين، لكنهم أيضا قاموا بشيء آخر ألا وهو تحويل هذه التقنيات لصالحهم ومنافسة الغرب عليها.
استخدام الأزمات
تميزت الفترة من 1970. إلى 2020. مرحلة نهوض الصين، بعدد من المتغيرات الهامة، أهمها:
أولا: تصاعد الأزمة التي يعاني منها النظام الرأسمالي، في الواقع العولمة هي تعبير عن هذه الأزمة؛ فبدأت منذ منتصف السبعينيات جهات غربية عليا؛ في تفكيك هذا النظام، الذي أصبح الآن مفتوحاً، إذ أعلن كلاوس شواب (رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي – دافوس)، بشكل صريح في 2012، أن الرأسمالية لم تعد تتوافق مع الشكل الحالي للعالم، هذا يعني أن “فوضى” تفكيك الرأسمالية قد جرى البدء فيها “بجدية تامة”، وقد مثل الوباء المزدوج (كوفيد -19)، وما رافقه من تأثيرات نفسية، فرصة وسلاحاً قوياً للنخبة العالمية الراغبة في تفكيك الركائز القانونية والسياسية والاجتماعية والثقافية للرأسمالية. وأنا هنا لا أتحدث عن الاقتصاد.
ثانيا: هناك أزمة هيكلية قديمة للرأسمالية متصاعدة منذ الستينيات، منحها تفكك الاتحاد السوفيتي القدرة على البقاء؛ عبر عملية استغلال منظم لبلدان المعسكر الشرقي؛ مما أجل أزمة الرأسمالية حتى عام 2008.
ثالثا: تأسست الحياة الجيدة، للاتحاد الأوروبي، بعد تدمير الاتحاد السوفيتي (ربما لا يكون هذا صدفة)، وامتدت لربع قرن، فقط! أما الآن، فإذا لم يفقد هذا الاتحاد القدرة على التنفس؛ فعلى الأقل قد أصبح يعاني من مشاكل خطيرة للغاية.
بحكم القانون، من المرجح أن يبقى الاتحاد الأوروبي على قيد الحياة، ولكن في الواقع أصبحنا نسمع أصوات متشائمة، تبالغ فتصفه بأنه يتحوّل إلى “وهم”!
رابعا: الصعود الكبير لتيار الإسلام السياسي في أوروبا؛ التي فتحت له عبر مبادرات كثيرة منها الهجرة أبوابها، ثم تسبب في خلق أزمة حقيقية، سواء في أنظمة الهجرة أو في إعاقته لاندماج المسلمين.
الإسلام السياسي… بين الصنعة والصناعة:
من الجدير بالذكر هنا القول: إن الأنجلو سكسون عملوا لفترة طويلة على إنشاء ودعم العديد من الحركات الإسلاموية، وقد توّج عملهم هذا بالنجاح، ومع ذلك من المرجح أن ينقلب هذا النجاح عليهم، على سبيل المثال عام 1930، كان للمخابرات البريطانية دور فعال للغاية؛ في دعم جماعة الإخوان المسلمين وهي (منظمة إرهابية محظورة في روسيا الاتحادية)، وفي أفغانستان اتخذ الأمريكيون الخطوة نفسها؛ التي شكلت نقطة تحول في نهضة الإسلاموية لا تقل أهمية عن ثورة الخميني في إيران.
قبل الأحداث في أفغانستان، تطورت المواجهة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية فيما تسمى “دول العالم الثالث” على النحو التالي: كان لدينا مشروعنا الحداثي الخاص بنا، أو المناهض للرأسمالية، أو بشكل أدق، غير رأسمالي، في المقابل كان للغرب مشروع رأسمالي خاص به. أي، كان هناك اثنان من المنافسين على مشروع الحداثة. ومع ذلك، في أفغانستان، اعتمد الأمريكيون (أو بعضهم على الأقل) على الإسلاميين -المناهضين للحداثة والمعادين لخط المستقبل! فتأمّل.
قد يكون الإسلام السياسي هو نتاج أصل تبلور في العالم الإسلامي؛ كما يزعمون، وهذا ليس خطأ، ولكنه أيضاً ما كان له أن يتمكن من التنامي بهذا الشكل الكبير لولا المجهودات (تُقرّأ: الاستغلالات التخادمية) والدعم الذي قدمته له بريطانيا؛ ثم الولايات المتحدة لاستخدامه في معاركهم ضد الخصوم، الآن قد أدركوا خطورة هذه اللعبة، ويقومون بتفكيك هذه المنظومة بالكامل (أو يحاولون)، بعدما حدث بين الطرفين أمر شبيه لما كتبه شكسبير عن المبارزة الشهيرة بين هاملت ولايرتس ووضع الملك السم في الكأس لهاملت حال انتصر، إلا أن الملكة بالخطأ شربت منه فراحت ضحية غدره ومغامرته.
خامسا: وهو العامل الأخير، صعود الصين مع تفكك الاتحاد السوفيتي وتدهور الأوضاع بعدها في روسيا.
في مايو (أيار) 1989، لم تسمح القيادة الصينية بوقوع الفوضى في البلاد، وتم قمع احتجاجات ساحة تيانانمن. صحيح تم هذا القمع بالدم، ولكن من وجهة نظر القيادة الصينية –آنذاك- إذا لم يتم قمعهم؛ فإن الحرب الأهلية التي يمكن أن تندلع في الصين من جراء الفوضى ستودي بحياة الملايين، في العموم تجنبت الصين مشاكل عديدة كان يمكن أن تحدث لها.
أما في الاتحاد السوفيتي، فقد كان الأمر مختلفاً تماماَ، فقد انقلب “فريق غورباتشوف وشركاه على ثوابت الدولة والمجتمع”، ومن خلال حركتين؛ في ثلاثة أيام تلاشى معها كل شيء، تماماً كما تلاشت روسيا الإمبراطورية في يومين أثناء ثورة 1917، وقدم غورباتشوف قبل تلاشي هذا الكيان؛ كل شيء طلبه الغرب منه.
لو نظرنا للمسألة بشكل تحليلي، سنجد أن هناك عملية متعددة الاتجاهات لدولتين: على سبيل المثال، في الخمسينيات والستينيات أصبح الاتحاد السوفيتي أقوى، والصين أضعف، وفي الثمانينيات حدث العكس.
قوة الاتحاد السوفيتي تعني ببساطة: ضعف الصين، وضعف الاتحاد السوفيتي عامل قوّة مضاف للصين.
بناءً على ذلك يطرح البعض عدة تساؤلات، منها:
هل كانت الصين مهتمة بإضعاف وكسر الاتحاد السوفيتي؟ بالطبع نعم. لكن هل كانت الصين مهتمة بانهيار روسيا؟ في رأيي، لا. هل القوى الغربية التي دعمت الصين كانت مهتمة بإضعاف وتدمير الاتحاد السوفيتي؟ نعم. لكن هل هذه القوى الغربية نفسها أرادت بعدها تدمير روسيا الاتحادية عام 1991؟ ليس الجميع.
أعتقد أنهم في وقت لاحق بالغرب قد أعربوا عن أسفهم لعدم قيامهم بذلك، ولكن أيضا في تلك اللحظة نجح التكامل مع الصين ووجود الأسلحة النووية في روسيا في منع حدوث هذا الأمر.
إذن، من هي القوى التي رفعت الصين، والتي يمكن أن نقرأ آثار أقدامها في رمال التاريخ؟
يقال في الإجابة عن هذا السؤال: بالتأكيد الأمريكيون، ومع ذلك يعتبر المسار البريطاني هو الأكثر أهمية في هذه العملية. إننا أمام آثار بريطانية واضحة بجانب الشركات والمصارف متعددة الجنسيات، التي تدير أعمالها المالية فوق الجزر البريطانية المتناثرة حول العالم؛ وفق هياكل وأنظمة فوق وطنية. عام 1956، وجه الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة ضربة حاسمة ونهاية للإمبراطورية البريطانية، بشكلها القديم أثناء أزمة السويس، بعد “ضياع” الهند كانت هذه الإمبراطورية قد ضعفت بشدة، ولكن بعد السويس كانت قد انتهت وسقطت.
لدى بريطانيا نخبة سياسية واقتصادية تمتلك مجموعة من الخبرات المعقدة والمبهرة في الوقت نفسه، وهنا أستعير وصف الجنرال بالجيش الإمبراطوري الروسي (إي آي فاندام) حين وصف النخب البريطانية بأنها “تمتلك فن النضال من أجل الحياة” ينطبق ذلك على بريطانيا نفسها التي تمتلك هذه الميزة، وكان لديها القدرة على أن تتصالح مع الحقيقة المرة، التي مفادها أن الإمبراطورية قد انقرضت؛ وتحولت إلى “حفنة من الرماد”، وعليهم محاولة إنشاء إمبراطورية على أساس مالي جديد.
كانت الدولة الوحيدة التي يمكن للبريطانيين أن يبذلوا فيها جهوداً تكلل بالنجاح لإنشاء إمبراطورية غير مرئية هي الصين، التي بدأ جزؤها الجنوبي في التطور منذ نهاية القرن الثامن عشر. علاوة على ذلك، فإن تجارة الأفيون لم تثرِ فقط البريطانيين، بل شملت جزءاً من النخبة الأمريكية، بالإضافة إلى جزء من العشائر البيروقراطية في جنوب الصين. وقد امتدت هذه الروابط منذ بداية القرن التاسع عشر إلى بداية القرن الحادي والعشرين.
في النصف الأول من ستينيات القرن الماضي، ربما نمَت العلاقة على كلا الجانبين الصيني والبريطاني بمساعدة وكلاء فرديين مستفيدين من قنواتهم عبر العشائر الصينية، والأنظمة المالية المغلقة، وبدأ المخطط البريطاني لبناء إمبراطورية غير مرئية ينبض بالحياة، مع ذلك كان هناك عقبة لابد من تجاوزها؛ ألا وهي الاتحاد السوفيتي الذي يعني وجوده عدم إمكانية هذه الإمبراطورية “غير المرئية”، على التوسع إلى أقصى إمكاناتها.
يأتي المستفيد الثاني، حسب هذه السردية، مشتركاً بين: الولايات المتحدة وألمانيا – يأتون في المركز الثاني من هذه العملية، لذا ليس من قبيل المصادفة أن انهيار الاتحاد السوفيتي تزامن مع ازدهار الولايات المتحدة في ظل كلينتون، ونمو الإمبراطورية المالية البريطانية، والانطلاقة الصينية، والبداية الحقيقية للاتحاد الأوروبي مع زيادة حادة في دور وأهمية ألمانيا في أوروبا، فحققت بالوسائل الاقتصادية والمالية ما سعت في الثلاثينيات لتحقيقه بالوسائل السياسية والعسكرية المتطرفة!
كانت قفزة الصين في السبعينيات والثمانينيات مرتبطة -إلى حد كبير- بالتنافس بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، إنه أمر كلاسيكي في التاريخ، كما ارتفعت أسبرطة بفضل المواجهة بين أثينا والإمبراطورية الفارسية، وكما تم التضخيم من دور فرنسا نتيجة الصراع بين أباطرة الإمبراطورية الرومانية المقدسة والباباوات، وظهرت القوى الألمانية في القرن التاسع عشر نتيجة الصراع الفرنسي البريطاني، والشيء نفسه حدث للصين أثناء الصراع السوفيتي الأمريكي، إنه “إلهام التاريخ” للقوى الكبرى في صراعاتها.
الماركسية المستقرة
سمعنا بما يسمى “الدرس الصيني لروسيا”؛ ومجموعة من الفرضيات المدعية الحكمة بأثر رجعي، وأن الاتحاد السوفيتي كان يمكنه أن يحقق ازدهاراً يماثل الصيني لو كان لدينا “ دنغ شياو بنغ الروسي”. وغالبا سنظل نسمع تكراراً لهذه النظريات نفسها حتى 2025.
يبدو هذا التصوّر شديد السطحية، فالصين لم يكن لديها شيء تمتلكه بالمقارنة بالاتحاد السوفيتي، ولا يوجد لديها نموذج اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي منافس للغرب يخشى منه، بل كانت أشبه بأرض جرداء سيقوم الغرب ببناء ما يراه متوافقاً مع مصالحه فيها ووفق ما يخدمه، بينما الاتحاد السوفيتي كان لديه نموذجه الصناعي المنافس للنموذج الغربي، ولكن في ذلك الزمن أصبح هناك نخبة سوفيتية حاكمة بدءاً من (يوري أندروبوف) المتجاهل لمسار تطور الاتحاد السوفيتي، ثم خلفته نخبة من كبار السن؛ على رأسها مجموعة من الشبان المغرورين: مثل غورباتشوف وشيفردنادزه، الذين تحدثوا -حينها- بسذاجة عن الاندماج مع الغرب.
كما يفوت أصحاب هذا التصور أن غورباتشوف كان مجرد بيدق، ولم يتم وضعه لتحقيق الغرض الذي قام به دنغ شياو بنغ.
كما يقول المثل الروسي “الجد لا يمكن أن يصبح جدة”؛ لا ألمانيا الشرقية التي كانت من ضمن أقوى عشرة اقتصاديات بالعالم، ولا الاتحاد السوفيتي الذي يعتمد جوهر اقتصاده على التصنيع، كان يمكن للغرب أن يسمح لهما بالاندماج في النظام العالمي، بل كان المطلوب تدمير الاتحاد السوفيتي والقضاء عليه، والاستحواذ على ألمانيا الشرقية؛ من قبل ألمانيا الغربية لضمها للمعسكر الغربي، لذلك لا ينبغي للمرء أن يصدق الحكايات الساذجة، أنه في الثمانينيات كان الاتحاد السوفيتي اقتصاديا في مراحله الأخيرة. هذه أسطورة اخترعتها “البيريسترويكا” و”ما بعد البيريسترويكا”. أما الصين فكانت أمراً آخر، مختلفاً جدًا؛ سمح لها الغرب بالاندماج بهدوء في منظومته، ولم يكن مطلوباً تدمير اقتصادها، بل رفعه وترقيته، واستغلال العمالة الصينية لصالح المنظومة الغربية الرأسمالية.
سؤال آخر يُطرح على طاولة النقاش بشكل متكرر: هل الصين تمثل تهديداً لروسيا؟ هناك وجهتا نظر متطرفتان:
الأولى: تقول: نعم الصين عدو، ولابد من الخوف منها.
الثانية: تنفي ذلك، بل وتؤكد أن الصين صديقة، وأننا إخوة إلى الأبد.
في الواقع لا يوجد في السياسة شيء يسمى الأصدقاء؛ هناك فقط حلفاء ومصالح.
الصين، حليف تكتيكي لروسيا الاتحادية في حالتها ووضعها الراهن. لكن من حيث المبدأ، أي دولة كبرى مثل الصين وعلى حدودنا فهي تشكل تهديداً، لا سيّما وأن لديها هذا العدد الضخم من السكان، مع وجود فائض من الذكور، الذين يعانون من مشاكل اقتصادية، ويحيطون بالحدود مع روسيا التي يبلغ طولها (4200) كم. التي تعاني من ضعف سكاني. لذلك، يجب أن نعمل على أساس الحكمة الثابتة: “نحن شعب مسالم لكن قطارنا المدرع يقف على جانب الطريق”.
وبالطبع، بالإضافة إلى ذلك، من الضروري إجراء دراسة شاملة للعالم بشكله الحالي للتعرف عليه أكثر ومعرفته بعمق،، وإدراك حجم المتغيرات التي طرأت عليه: على أن تبدأ هذه الدراسات بمعرفة أنفسنا أولا، وأعدائنا ثانيا، وجيراننا ثالثا.
المفارقة هي أننا -في روسيا- في وسط هذه الأزمة النهائية للرأسمالية، لا نمتلك معرفة حقيقية عنها ولا عن طبيعة هذه الأزمة، ولا عن الغرب، ولا عن الشرق، ولا عن العالم ككل، بل حتى عن روسيا نفسها!
والأسوأ من ذلك أن روسيا وفق ما يبدو أنها خطة ممنهجة؛ تمضي في طريق إن لم يكن صحراويا فهو شبه صحراوي، فمنذ عام 1991؛ ألقت الماركسية في سلة المهملات، ولم تكتفِ بذلك وحسب، بل قررت التخلص من كل النظريات تماما! قال ستالين ذات مرة: “بدون نظرية، سنموت، وليس لدينا سوى الموت أو الموت”.
تطور العلوم الاجتماعية: الغرب يدرس ماركس وروسيا تزيله؟
لقد تطورت نظريات العلوم الاجتماعية لدينا في روسيا بشكل محدود للغاية ومنقطع منذ منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، ولم يكن هناك سوى أيديولوجية جامدة؛ أعاقت تدريجيا التطور الحقيقي للنظرية الماركسية، ولّد هذا الوضع المتجمد اهتماما كبيرا بالعلوم الاجتماعية القادمة من الغرب، ولكن في الغالب لم تلق اهتماما أو عناية تذكر. أما بعد عام 1991، فقد تدفق تيار موحل بالنظريات والمفاهيم الغربية التي تنتمي للدرجة الثانية: منها نظريات كلاسيكية قديمة حول “الشمولية”، وغيرها من المواد التي عفّى عليها الزمن، وجرى إعادة تدويرها في روسيا؛ عبر المنح الغربية لتطويرها، وتشكيل مجموعة كاملة من المتخصصين في العلوم الاجتماعية، تحولوا إلى “ كومبرادور” فكري موالٍ لها ومدافع عنها، لا أتحدث عن علوم ونظريات؛ بل عن ثقافة تحولت مع الوقت لعبارات معادية لروسيا في كثير من الأحيان. بينما يتزايد عدد الأعمال في المؤسسات التعليمية والنخبوية الغربية حول ماركس وتدريس الماركسية، فإن روسيا “نظيفة” تخلو تماماً من هذه الدراسات، ولكن قد يبدو هذا الأمر منطقياً للغاية: لماذا يمتلك بلد تابع أسلحة فكرية قوية؟!
يكفي لهذا البلد أن يتغذى فكرياً إن أراد على قصاصات فكرية؛ لأمثال كارل بوبر وفريدريش فون هايك، وغيرهما من العينة الفكرية نفسها التي أهال الغرب نفسه عليها التراب.
علم جديد عن المجتمع.. نظرية جديدة؟
لفهم العالم الحديث والإجابة عن تحدياته، من الضروري تطوير نظرية جديدة، وخلق معارف جديدة بشكل أساسي. في خلال هذه الفترة التي بدأ التفكير جديا فيها لعالم ما بعد النظام الحالي، واهتمام العديد من الأكاديميات الغربية العريقة بإعادة قراءة التراث الماركسي، وعدم الوصول لتصور واضح لشكل التحول المقبل عليه العالم. حتى إن أجهزة المخابرات بدت تشعر بأنها أمام لغز، وغير قادرة على توقع مآلات هذا التغير الجديد، وهو ما دفعها في البلدان الأنجلو سكسونية، إلى جانب العديد من أقسام الدراسات التاريخية والاجتماعية الرائدة في بريطانيا، لتدريب المؤرخين على تخصصات جديدة مع ظهور مصطلحات لم يكن لها وجود تقليدي مثل (المؤرخ الاستقصائي – The Investigative Historian). أو (مؤرخ النظم – Systems Historian).
حتى لا نعيد كتابة التعليقات على النظريات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الغربية من الدرجة الثانية؛ ونستمر في تدمير تعليمنا العالي، وتدمير الأفكار الأساسية في مجال العلوم الاجتماعية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ما نراه “نزهة على الهامش” إلى “نزهة في سلة المهملات” أو الجلوس وانتظار تحقق “الأحلام والمعجزات” ببلد الحمقى. لمنع حدوث ذلك، نحتاج إلى علم جديد عن المجتمع. هذا، بالطبع، ليس شرطا كافيا للمضي قدما في هذا التطوير، ولكنه ضروري. الشرط الكافي هو إرادة ملحة، لا تسمح بالجلوس إلى الأبد في الدفاع وتقديم الأعذار، ولكنها تجعلك قادراً على الهجوم! نحتاج إلى صورة حقيقية عن العالم المعاصر لنفهمه بشكل أكبر وأعمق وأشمل، لأن هذا الفهم سيشكل أقوى سلاح في حرب نفسية تاريخية. وفي تطوير مثل هذه الصورة عن العالم، بطبيعة الحال، واحدة من أهم المهام هي دراسة الصين كنظام، ومكانها المتوقع في العالم الجديد.
رابط المصدر:
