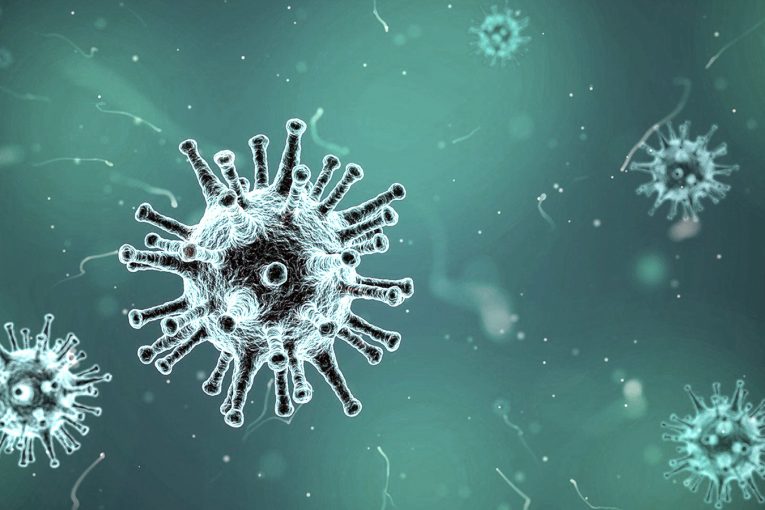
د. عبد الله بن خالد بن سعود الكبير\
في فترة زمنية أقل من أربعة أشهر حتى الآن، خلّفت جائحة فيروس «كورونا الجديد» وراءها دماراً هائلاً في الأرواح، والاقتصاد، والحياة الاجتماعية. للمقارنة والمقاربة، فإن عدد ضحايا الإرهاب في العالم كله خلال العامين 2017 و2018 بلغ نحو 34.800 شخص، بينما خلّفت هذه الجائحة وراءها في أقل من أربعة أشهر أكثر من 104.000 حالة وفاة. أما بالنسبة للاقتصاد فقد بدأ في الانكماش فعلاً وبسرعة أكبر من وتيرته في الأيام الأولى للأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008. ولا تسل عن حال الحياة العامة والاجتماعية في زمن التباعد الاجتماعي حيث يقبع أكثر من ثلث سكان العالم حالياً تحت نوع أو آخر من القيود على الحركة والتجول.
وإن كان من المبكر الحديث حول مآلات العالم وكيف سيكون شكله ما بعد هذه الجائحة، فإنه على الأغلب ستعود الحياة الاجتماعية لحركتها العفويّة، وإنْ بأسلوب حياة مختلف وتبنّ أكبر للتقنية والخدمات الإلكترونية والتي خفّفت بشدة من وطأة عزلة هذا الفيروس على البشر. كما أن الأنظمة الصحية في كثير من الدول ستستلهم العديد من الدروس من هذه الجائحة لتكون أكثر صلابة وقدرة على التعامل مع الأزمات مستقبلاً، خصوصاً مع إدراك العديد من الدول فداحة ترشيد الإنفاق على النظام الصحي وخطورة ذلك على أمنها الإنساني. أما الاقتصاد فهو بكل تأكيد سيعاود الصعود والتعافي، وإن كان من الصعب التكهّن بمدى ومدة ذلك بدون معرفة أمد الأزمة نفسها وحجم الأضرار التي ستخلّفها. كما أنه سيكون هناك تفاوت بين الدول فيما يتعلق بمدى وسرعة تعافيها من الآثار الاقتصادية لهذه الأزمة بحسب متانة اقتصاداتها ومرونتها. إلا أن التغير الذي تبدو احتمالية حدوثه كبيرة يتعلق بشكل النظام والتعاون الدولي الجديد.
قد يتصوَّر البعض أنَّ أزمة أو جائحة عالمية من هذا النوع الذي نعيشه الآن ستستدعي تعاوناً وتكاتفاً دولياً للخروج منها بأقل الأضرار على الجميع. إلا أنَّ الذي يحدث أن أغلب الدول، كأغلب البشر، حين تواجه تحديات ومخاوف تهدد أمنها وبقاءها، تقدّم نفسها وسلامتها على غيرها، مذكّرة إيانا بتنظير توماس هوبز لـ«حالة الطبيعة» كتشبيه مستعار للعلاقات بين الدول ذات السيادة في غياب قوة عليا ضامنة لسلامة الجميع. حتى الآن، فرضت ثمانون دولة تقريباً قيوداً على تصدير المعدات واللوازم الطبية، منها أربعون دولة منعت ذلك تماماً. قبل عدة أيام ذكر بيتر نافارو، مساعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومستشاره للتجارة، خلال مؤتمر الرئيس الصحافي اليومي، أن «من الأمور التي علّمتهم إيّاها هذه الأزمة أن (الولايات المتحدة) معتمدة بشكل خطير على سلسلة التوريد العالمية» فيما يتعلق بالأدوية والمعدات واللوازم الطبية، وأن هذا الواقع وهذه الأزمة تؤكد أنه «بغض النظر عن عدد الاتفاقيات أو التحالفات أو المكالمات التي ستقوم بها، فحين تحين الشدائد والأزمات تكون في خطر ألا تجد ما تحتاج إليه». بينما اتهم وزير الداخلية الألماني الولايات المتحدة بمصادرتها لـ200 ألف كمامة كانت قد طلبتها من منتج أميركي وهي في طريقها إلى ألمانيا عبر بانكوك، وذكّر بأن ألمانيا تنظر لهذا الفعل على أنه «قرصنة حديثة» وأنه من غير المسموح «التصرف بهذا الشكل بين الشركاء عبر الأطلسي».
الوضع داخل أوروبا نفسها ليس بالأفضل حالاً، فالدول التي تتشارك منطقة اليورو ليست متساوية في أوضاعها الاقتصادية وقدراتها على الاستجابة لتحديات الوضع الحالي، وإنْ لم يتم التوصل لاتفاق لتقاسم العبء المالي بين دول منطقة اليورو فإن ذلك قد يهدد تماسكها وينبئ باحتمالية انقسامات داخل الكيان مستقبلاً. وقد صرّح رئيس الوزراء الإيطالي في مارس (آذار) بأنه «إن لم ترتقِ أوروبا لمستوى هذا التحدي غير المسبوق، فإن النظام الأوروبي بأكمله سيفقد سبب وجوده لدى الناس». أما الرئيس الصربي فقد كان أكثر مباشرة حين قال إن «التضامن الأوروبي ليس له وجود… الدولة الوحيدة التي تستطيع مساعدتنا في هذا الوضع الصعب هي الصين. أما البقية، فشكراً على لا شيء».
أما الصين، فقد حاولت مبكراً التستّر على الوباء ومعدلات انتشاره، وهي المحاولات التي انطلت مع الأسف حتى على منظمة الصحة العالمية وأضرّت بلا شك بقدرة العديد من دول العالم على الاستعداد المبكر، واستدعت الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤخراً وعلى حسابه في موقع «تويتر» إلى انتقاد المنظمة العالمية لكونها تميل إلى الصين رغم أن أغلب ميزانيتها تأتي من الولايات المتحدة، على حد قوله، مهدداً بإعادة النظر في ذلك. إلا أن الصين حالياً تحاول التأثير في طريقة سرد الفصول الأخيرة من القصة واستثمار الأزمة لصالحها من خلال حملة دعائية ضخمة تروّج لقصة نجاحها وقدرتها على السيطرة على الوباء، رغم تحفّظ العديد من المراقبين على شفافية إحصاءات ومعدلات الإصابة والوفاة الصادرة منها، وكذلك مساعدة الدول المتضررة والموبوءة، كإيطاليا وصربيا وغيرها، بالإمدادات والأطقم الطبية ونقل الخبرات في ظل عدم رغبة أو قدرة الدول الأوروبية الجارة.
إن أغلب الاستجابات الجادّة التي تمّت حتى الآن لمجابهة آثار هذه الجائحة كانت على مستوى وطني. هذا لا يعني عدم وجود محاولات أخرى لحشد دعم وتعاون دولي نأمل في تضافرها ونجاحها. والحقيقة أن جهود المملكة العربية السعودية في هذا الصدد كانت ولا تزال قياديّة ورائدة. فها هي تدعو لاجتماع منظمة أوبك+ في محاولة أخرى لحشد تعاون دولي لضمان استقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي بعد أن كانت قد رفضت روسيا في اجتماع سابق تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لمواجهة تباطؤ الطلب العالمي والانكماش الاقتصادي بسبب جائحة «كورونا». كما أنها كانت قد دعت من خلال رئاستها لمجموعة العشرين لهذا العام لاجتماع قمة افتراضي استثنائي نهاية الشهر الماضي تم من خلاله التعهد بضخ 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، ومحاولة تعزيز التعاون الدولي. سبق اجتماع القمة هذا ولحقه اجتماعات استثنائية لوزراء المالية والتجارة والاستثمار في دول المجموعة، كما دعت المملكة لاجتماع افتراضي استثنائي يعقد لأول مرة لوزراء الطاقة في 10 أبريل (نيسان) الحالي في محاولة لتخفيف آثار جائحة «كورونا» على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.
ذكر وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر في مقالة له نشرتها «وول ستريت جورنال» مؤخراً أهمية المحافظة على ثقة العامة بمؤسسات الدولة في خضم هذه الأزمة، محذّراً من فشلها لما سيكون له من نتائج سلبية؛ حيث «تتماسك وتزدهر الأوطان بالإيمان بأن مؤسساتها تستطيع استشراف الكوارث، واحتواء تبعاتها، وإعادة الاستقرار». لا شك أن مقولة الدبلوماسي المخضرم صحيحة، إلا أنها لا تنطبق فقط على المستوى المحلي بل والعالمي أيضاً فيما يخص الدول وثقتها بالمؤسسات الدولية. وهنا القضية أخطر وأعمق لأن فشل المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية، بدءاً من منظمة الصحة العالمية التي فشلت ابتداءً في إدراك خطر هذا الفيروس وتحذير الدول منه، انتهاءً بالاتحاد الأوروبي واحتمال فشله الذريع في احتواء آثار هذه الأزمة على العديد من أعضائه، من شأنه أن يقوّي ويسرّع في تعزيز الاتجاهات الشعبوية والحمائية والقومية المتطرّفة والتي كانت قد بدأت في الصعود والانتشار ما قبل الأزمة، مغذّية بعض المشاعر العنصريّة ومشكّكة في نيات وفاعلية المنظمات الدولية وجدوى الانضمام لتلك الإقليمية.
إن تآكل ثقة الدول، وكذلك العامة، بقدرة المؤسسات الدولية والإقليمية على التعامل مع هذه الأزمات وتخفيف أضرارها سيكون له تبعات سلبية على مستقبل التعدّدية والتعاون الدولي. لا تزال هذه الجائحة فيما يبدو في بداياتها، أو على الأقل في نصفها الأول. فلم تصل العديد من الدول بعد في استشرافاتها الوبائية إلى مرحلة قمة الهرم بعد. فماذا سيحمل لنا هذا الفيروس من آثار وتبعات لم تظهر بعد؟ وهل سنقبل على مرحلة انكفاء ذاتي عالمي؟ أم أن دول العالم ستستشعر عدم قدرتها منفردة على مجابهة التحدّيات والتهديدات العابرة للحدود والهويّات، وأنه لا مناص من التعاون والتكاتف؟ نحن نعيش في مرحلة مفصلية من تاريخ العالم يصعب حالياً التكهّن بآثارها المستقبلية على جميع المستويات. لكن من شبه المؤكد، كما وصف المفكر أمين معلوف بعض الحوادث الماضية التي غيرت مجرى الأحداث من بعدها، أنها ستكون من أهم فواصل الكتب في سجلّ الزمن الكبير.
– أستاذ مساعد في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
